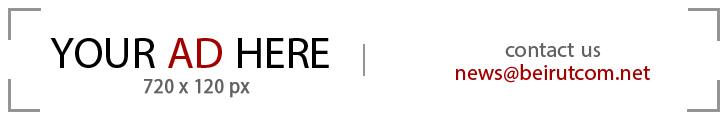المخرجة اللبنانية العالمية نادين لبكي تتحدث عن تفاصيل فيلمها السينمائي الجديد “كفرناحوم” والهدف الأساس لإخراجه الى النور ، وتكشف عن هدفها من ورائه بعدما عايشت أبطاله في الواقع وشهدت على المعاناة الانسانية الصعبة التي عرفوها:
لماذا اخترتِ كفرناحوم اسمًا لهذا الفيلم؟
فرض الاسم نفسه دون أن أشعر بذلك.عندما بدأت بالتفكير بالفيلم، اقترح عليّ زوجي خالد بأن أكتب جميع المواضيع التي كنتُ أودّالتطرّق إليهاعلى لوحٍ أبيض في منتصف غرفة الجلوس في منزلنا. وهي طريقة اتّبعها عادةً لدراسة الأفكار التي أريد تطويرها. وعندما عدت إلى ذلك اللّوح بعد فترة معينة، أخبرتُ خالد بأنني أشعر أن كافة هذه القضايا والأعباء والهموم أشبه بجحيم وخراب لا يطاق (أي كفرناحوم) ومن هنا جاء اسم الفيلم.
وما كانت الموضوعات التيكتبتِها على هذا اللوح؟
كنت دائماً أشعر بأهميّة نقاش النظام القائم وتناقضاته من خلال أفلامي. ولا أكتفي بمجرد الطرح أو النقاش فحسب، بل وأسعى أيضًا إلى تصوّرِ أنظمةٍ بديلةٍ.
في بداية كفرناحوم، كانت المواضيع التي شغلت بالي متمثلة في: أوّلاً، قضايا المهاجرين غير الشرعيين، والأطفال الذين يقاسون سوء المعاملة. وثانيا، العمال المهاجرين، وفكرة الحدود وغرابة وجودها،ففي الحقيقة نحن لا نزال نحتاج إلى ورقةٍ لكي نثبت وجودنا في مكانٍ ما.رغم أنّ بإمكان هذه الورقة أن تكون باطلةً. إضافةً إلى العنصرية والخوف من الآخر، وعدم الاكتراث باتفاقية حقوق الطفل المشرّع عنها في الأمم المتحدة.
ولكن انتهى بك الأمر الى جعل قضية الطفولة محورًا أساسيًا لفيلمك…
قرّرتُ التركيز على قضيّة الأطفال الذين يقاسون سوء المعاملة بالتوازي مع هذا العصف الذهني الذي مررت به لبلورة فكرة الفيلم. فقد مررتُ بموقف أثّر فيّ جدًّا وأشعرني بأهمية هذا الطرح، إذ كنتُ عائدةً من إحدى الحفلات عند الساعة الواحدة صباحاً، وتوقّفتُ عند إحدى الإشارات الضوئية فلمحت عيناي طفلاً تحت نافذة سيارتيتماماً, كان نائماً في حضن أمه التي كانت جالسةً تتسوّل على قارعة الطريق. وتمثّلت الصدمة بأن هذا الطفل لم يكن يبكي، ولكن كلّ ما كان يريده هو أن ينامفقط. لم تفارق صورته مخيّلتيوهو يغمض عينيه.عندما وصلت إلى منزلي، كان لابدّ لي بأن افعل شيئًا حيال تلك الصورة، فرسمت وجه طفلٍ يصرخ في وجه أناسٍ بالغين، ويلومهم لأنهم جلبوه إلى عالمٍ سلب منه كل حقوقه. وهكذا بدأت فكرة كفرناحوم بالنموّ، وكانت الطّفولة هي نقطة الانطلاق، لأنها المرحلة التي ترسم وتحدّد ما تبقّى من حياتنا.
وما هو محور الفيلم؟
يسرد كفرناحوم قصة زين الذي يبلغ من العمر 12 عاماً، فيقرّر أن يرفع قضيةً على والديه الذين أحضروه إلى العالم دون أن يكونوا قادرين على تربيته تربيةً سوية، بل وأن يمنحوه الحبحتى. وكأن معركة هذا الطفل، الذي قاسى سوء المعاملة والذي لم يكن والداه أهلاً لتلك المهمة، تشكّل الرمز والصدى لصرخات كلّ أولئك الأطفال الذين أهملتهم أنظمتنا. إنه اتهامٌ يعبّر عن أطفال العالم ترسمُه عيونٌ صادقة…
ما هي “رسالة التغيير” التي تتجلّى في كفرناحوم وأعمالك بالمجمل؟
أرى أن السينما هي وسيلةٌ لطرح الأسئلة قبل كل شيء، بما في ذلك الأسئلة التي أطرحها على نفسي، بشأن النظام الحالي. كما إنها وسيلة أقوم من خلالها برسم تصوّري للعالم الذي أتطوّر، أنا شخصياً، ضمن دائرته. كنت ولازلت مثالية جدًا، إذ لا زلت أؤمن بقوة السينما.فحتى ولو كانت أعمالي، وكفرناحوم تحديدًا، ترسم صورةً صادمةً ومجرّدة للواقع، فإنني لازلت مقتنعةٌ بأن السينما، وإن عجزت عن تغيير الواقع، فإنها تستطيع أن تؤسّس لنقاشٍ مثمرٍ أو أن تدفع الناس الى التفكير.
في كفرناحوم، اخترت بأن أجعل من مهنتي سلاحًا، عوضًا عن مجرّد شجب مصير هذا الطفل الذي رأيته في الشارع والاستسلام لشعور العجز. وقررت إنجاز العمل أملاً بأن يكون لي أثرٌ من خلاله على حياة هذا الطفل ، حتى ولو تمّ ذلك من خلاللفت انتباه الناس وتوعيتهم لهذه المشكلة. والذي حفزّني على تقديم العمل هو حاجتي لأن أرسم صورةً حقيقية للوجه الخفي لبيروت (ومعظم المدن الكبرى)، وأن أتوّغل إلى الحياة اليومية لأولئك الذين كان الفقر المدقع هو مصير محتوم عليهم ولا مفرّ لهم منه.
جميع الممثّلين هم أشخاصٌ يعيشون حياةً قريبةً من حياة شخصياتهم في الفيلم. لماذا اخترتِ ذلك؟
بالفعل، تُعتبر حياة زين على أرض الواقع مشابهةٌ لحياة شخصيته في الفيلم ومن أكثر من زاوية.كذلك بالنسبة إلى رحيل، السيدة التي تعيش بلا أوراق رسمية. أما شخصية أم زين فقد استوحيتها من امرأةٍ قابلتها، كانت قد أنجبت 16 طفلًا، وتعيش في ظروفٍ مشابهةٍ للظروف التي يصوّرها الفيلم، وقد مات ستةٌ من أطفالها، فيما تُرك البعض الآخر في دورٍ للأيتام لأنها لم تستطع الاعتناء بهم.
أما السيدة التي لعبت دور كوثر فقد كانت هي بالفعل تطعم أولادها من مكعبات ثلج مغطاة بالسكر. وحتى القاضي فكان يعمل قاضيًا في الواقع. كنت أرى بأنني الوحيدة التي لم تعايش ظروفًا تُماثل ما يحدث على الشاشة، ولهذا أردت بأن يكون دوري هامشياً قدر الإمكان.
لطالما كانت لديّ بعض التحفظات على استخدام كلمة “لعب الدور” عند الإشارة إلى ممثلي السينما، وخصوصًا في فيلم كفرناحوم الذي كانت فيه المصداقية أولويةً هامة، بل أرى أنني أدين لجميع من كان هذا الفيلم صرخةً لقضيتهم.
لقد كان من الضروري أن يدرك الممثّلون نوعيّة الظروف التي نريد إبرازها، لإعطاءهم شرعيةً حينما يقومون بالحديث عن قضاياهم. وأظن بأن مهمة تجسيد شخصيات تحمل كل هذه الهموم والآلام أشبه بمهمة مستحيلة للممثّلين بشكل عام. ومن هذا المنطلق، فقد رغبت بأن يغوص فيلمي في أعماق شخصياتي وليس العكس، ولهذا كان اختيار أشخاص غير محترفين للتمثيل أمرًا بديهيًا. طوال فترة التصوير، كنت مؤمنةً بأن هناك قوةً خفيةً كانت ترعىالفيلم، وشاءت الأقدار بأن يسير كلّ شيءٍ كما أردنا. فكنت أنا أكتب شخصياتي، وكنت أشاهدها وهي تقفز من الصفحات إلى الشارع لتجدها أعين من كان مسؤولاً عن اختيار الممثلين. كنت أطلب منهم فقط أن يكونوا على طبيعتهم لأن حقيقتهم كانت كافية، أما أنا فوقعت في غرامهم. وبعيدًا عن إعجابي بمدى صدقهم على الشاشة، فقد كنت سعيدةً لأن الفيلم منحهم منبراً يعبّرون فيه عن أنفسهم، ومساحةً يستطيعون من خلالها أن يعبروا عن معاناتهم.
بعيدًا عن الاتهامات التي يوجهها زين لأهله، فإن محرّك الفيلم هو رحلة هذا الصبي الذي لا يحمل أي أوراق رسمية..
لا يملك زين أي وثائق، ويعني هذا، بالمفهوم القانوني، بأنه غير موجود. تختزل قضيته مشكلةً أبرزناها على مدار الفيلم وتتمثّل في شرعية وجود الإنسان. خلال بحثي،لقد وجدت العديد من الحالات المشابهةلأطفالٍ ولدوا بدون توثيق رسمي لأن ضيق حال ذويهم منعهم من ذلك، وخطف الموت كثيرًا منهم غالبًا بسبب الإهمال أو سوء التغذية، أو ببساطة، لغياب الرعاية الطبية. يموت هؤلاء الأطفال دون أن يلحظهم أحد، وكأنهم بلا وجود في هذه الحياة. وجميعهم يقولون، وبحثي في هذا الموضوع يبرهن ذلك، أي بأنهم غير سعداء بمجيئهم إلى هذا العالم.
بدأ التصوير بعد ولادتك لابنتك الثانية بفترةٍ وجيزة…
ابنتي مايرون ويوناس متقاربتان جداً في العمر. كنت أنا وشخصية رحيل نرضع ابنتيّنا في نفس الوقت، وقد أدت هذه التجربة المزدوجة – بين موقع التصوير وبين حياتي الشخصية حينما كان عليّ أن أحاول التوازن بين الأمرين – إلى تعميق علاقتي بالفيلم. حتى عندما توجّب علي أن أغادر إلى المنزل بين كل لقطةٍ وأخرى لكي أرضع ابنتي، وحتى إن كنت بالكاد أجد أي وقتٍ لأنام، كان هناك قوةٌ لا أستطيع شرحها انبعثت بداخلي وحملتني على إتمام التصوير. لقد كان ذلك حقًا أمرًا مذهلًا.
شخصية رحيل من أثيوبيا، فهل كان هذا خياراً مقصوداً؟
أردت أن تكون الشخصية الأساسية امرأةً ذات بشرة سمراء. هناك الكثير من الفتيات في لبنان مثل رحيل، فهن يتركن أطفالهن ويذهبن ليعملن لصالح عوائل أخرى، ويصبحن مجبراتٍ على الانسلاخ من أي عاطفة، وحتى من حق الحب. وسرعان ما يقعنّ ضحيةً للعنصرية أو يواجهن المعاملة السيئة من الأشخاص الذين يعملون لديهم، والذين لا يعتبرونهنّ موّظفات لهن حقوقهن، فقط لأنهن تنحدرنَ من عرقٍ مختلف. لا يُسمح لهنّ بالإنجاب أو بأن يظهرن حبهنّ لأطفالهنّ… وبالعودة إلى الفيلم، في المشهد الذي يدور في بيت كاتب العدل(الذي يُضطر فيه إحدى الشخصيات بأن يتظاهر بأنها استغنت عن رحيل من أجل موّظفة فيلبينية ستُضفي على العائلة مكانة أعلى). يجسّد هذا المشهد عدم اتساق هذا النظام الذي لا يكتفي فقط باعتبار هؤلاء النسوة غرضاً يُباع ويشترى، بل ويصنّفهم أيضًا. لقد تمثّلت رغبتي، لهذا السبب، في الاحتفاء بهؤلاء النسوة كما يستحقن.
ما هي أوجه الشبه بين الفيلم وما حدث في الواقع؟
كان هناك عدداً من نقاط التقاطع، وهو ما جعل هذه المغامرة تعبق بسحرٍ جميل. أولاً، في اليوم الذي صوّرنا فيه المشهد الذي تُعتقل فيه رحيل في مقهى الانترنت، حدث أن اعتقلت حقاً لعدم امتلاكها لأي وثائق. كان الأمر أقرب إلى المستحيل. عندما تبدأ بالبكاء وهي تُلقى في السجن، كانت الدموع التي تسيل من عينيها دموعًا حقيقية فقد عانت من هذه التجربة فعليًا وقاست آلامها. وكذلك الأمر بالنسبة ليوناسالتي اعُتقل والداها خلال تصوير الفيلم. الفتاة الصغيرة التي لعبت دورها (واسمها تريجور) اضطرت للعيش مع مسؤولة اختيار الممثلين لثلاثة أسابيع كاملة. وطبعًا منحت كل هذه اللحظات التي اشتبك بها الواقع بالخيال مصداقيةً كبيرةً لهذا الفيلم.
يتناول الفيلم أيضاً مسألة المهاجرين. هل كان هذا أمرًا مهمًا بالنسبة لك؟
تناولنا هذه القضية من خلال شخصية ميسون في الفيلم. كان من المهم أن نتحدّث عن ذلك عبر الأطفال الذين تزخر مخيّلاتهم بهذه الرحلات الواعدة الذين لا يعرفون عنها شيئاً. هؤلاء الأطفال الذين يُقذّفون إلى حياة البلوغ، إلى حياةٍ قاسيةٍ وصعبةٍ رغماً عنهم.
هل تعتبرين هذا الفيلم فيلمًا وثائقيًا؟
كفرناحوم قصةٌ روائية، إلا أن جميع عناصرها هي أمورٌ عايشتها وشهدتها خلال بحثي. فلم يكن هناك أي شيءٍ قد اختلق أو كان من وحي الخيال، بل إن كل ما نراه هو نتاج زياراتي لمناطق فقيرة، ومراكز الاحتجاز، وسجون الأحداث التي زرتها وحيدةً، مخفيةً هويتي وراء قبعةٍ ونظاراتٍ شمسية. استغرق الفيلم ثلاث سنواتٍ من البحث، وكان يلزم علي أن أكون متعمّقةً ومتمرسةً في الموضوع الذي أردت أن أتناوله، أن أرى كل شيءٍ بالعين المجرّدة بدلاً من أن أعايشها. وقد أدركت بأنني أتناول قضيةً حساسةً ومعقّدة وأنا أقوم بكل ذلك، ذلك لأنها قضيةٌ لمستني أكثر وأكثر ربما لأنها كانت غريبةً وغير مألوفةً بالنسبة لي. وقد أدركت بأن علي أن أنصهر بواقع هؤلاء الناس، أن أتعمّق في قصصهم وغضبهم وإحباطهم،لكي أستطيع أن أرويها وأرصدها في الفيلم. كان عليّ أن أؤمن بالقصة قبل أن أكون قادرة على سردها. صوّرنا الفيلم في مناطق فقيرة بين جدرانٍ شهدت مآسٍ مماثلة، باستخدام أدواتٍ متواضعة وممثّلين طُلب منهم، بكل بساطة، أن يكونوا على طبيعتهم.
وقد حرصت على إخراج التجربة بطريقةٍ تخدم العمل. ولهذا السبب استغرق التصوير ستة أشهر، ووجدنا في النهاية بأن بين أيدينا أكثر من 520 ساعةٍ من المشاهد التي تم تصويرها.
ولكن تبقى فكرة طفلٍ يحاكم والديه فكرةً غير واقعية…
محاكمة زين لأهله هي رمزيةٌ تختزل أسماء جميع الأطفال الذين يجب عليهم أن يطالبوا أهلهم بأبسط الحقوق، وهم الذين لم يختاروا أن يولدوا، حقهم أن ينالوا الحب على الأقل. أردت أن تحمل المحاكمة حسّاً من الواقعية عبر تدخل كاميرات التلفزيون ووسائل الإعلام المختلفة التي تساعد زين بأن يأخذ قضيته إلى المحكمة.
وهناك، في قاعة المحكمة، يكون اللقاء الذي يجمع كافة شخصيات الفيلم…
كانت فكرة قاعة المحكمة ضروريةً لإضفاء المصداقية للدفاع عن مجتمع كامل. فكانت جلسة الاستماع هذه أشبه بمنصة لأصواتهم، المقموعة والمهملة، أملًا في أن تصل أخيرًا إلى الآذان. ولهذا طلبت من أم زين، عندما كان عليها أن تدافع عن نفسها أمام القاضي، أن تفعل ما كان لها أن تفعله إن طُلب منها حقاً بأن تدافع عن قضيتها أمام قاضٍ في الحقيقة. فلقد عبّرت عن نفسها بصفتها كوثر (اسم شخصيتها في الفيلم)، وهو ما سمح لها بأن تعبّر عما قيّدها طوال حياتها. قمنا أيضًا بتنفيذ فكرة المحكمة لتضعنا أمام فشلنا، وعجزنا عن القيام بأي شيءٍ في وجه مستنقع الفقر الذي بات العالم يسقط فيه.
ولكن ألا يجبرنا ذلك الإطار على أن نرتدي نحن عباءة القاضي؟
على العكس تمامًا، فإذا كانت المحكمة قد أجبرتنا على أمرٍ ما، فهو أن نرى ونسمع وجهات النظر والآراء المختلفة. فنحن نلوم الأهل في البداية، ومن ثم نسامحهم.
لقد استوحيت وجهة النظر تلك من تجربتي الخاصة، فعندما قابلت أمهاتٍ أهملن حقوق أطفالهن، وجدت نفسي أصدّر أحكامي عليهم. ولكن تعمّقت أكثر بقصصهم، والجحيم الذي عشن فيه، والجهل والحماقات التي أدّت بهم إلى أن يظلموا أطفالهم على هذا النحو المخيف. كانت هذه الاكتشافات أشبه بصفعةٍ على الوجه. ووقتها تساءلت: “كيف لي أن أسمح لنفسي بأن أكره هؤلاء الناس أو أطلق أحكامي عنهم، وأنا لا أعرف شيءٍ عن تجاربهم أو واقعهم اليومي؟”
هل تعتبرين كفرناحوم فيلمًا لبنانيًا؟
على صعيد الإنتاج والمكان، فهو كذلك بكل تأكيد. ولكن القصة هي قصة كل إنسانٍ لا يملك حقوقه الأساسية، أو حالت العوائق بينه وبين حصوله على التعليم، والرعاية الصحية، والحب أيضاً. إنّ هذا العالم المظلم الذي تتنقّل هذه الشخصيات بداخله هو اختزالٌ لحقبة، واختزالٌ لمصير كل مدينةٍ كبيرةٍ في هذا العالم.
يبدو بأن هذا الفيلم مثّل نقلةً في مسيرتك، فهو يبتعد عن أعمالك السابقة التي يسودها حسٌّ من التفاؤل…
ينجح زين في الحصول على وثائقه في نهاية الفيلم، وتجد رحيل طريقةً للتواصل مع ابنها… ونجحنا أيضاً بأن نسوّي أمورهم القانونية في لبنان على أرض الواقع. فلمرةٍ واحدة لم أرد بأن تكون النهاية السعيدة مقيّدةً بحدود الشاشة، وآمل بأن يحدث ذلك في الحياة الواقع عبر النقاش الذي يستثيره هذا الفيلم. لقد كان “كفرناحوم” مُتنفسّاً للممثّلين، ومساحةً سمحت لهم بأن يعبّروا عن معاناتهم وأن يستمع لهم الآخرون. وهذا بحدّ ذاته هو انتصار.
ما هي طموحاتك فيما يتعلق بـ كفرناحوم؟
أقصى ما أريده هو أن يدفع هذا الفيلم المسؤولين وأصحاب القرار إلى سنّ قانونٍ يكون أساس بنيةٍ حقيقيةٍ تحمي الذين تعرّضوا لمعاملةٍ سيئةٍ وكذلك الأطفال المهملين. آمل أن نصون، ولو قليلاً، حرمة هؤلاء الأطفال، الذين لم يأتوا إلى هذا العالم يإرادتهم، أو ربما كانوا مجرد تفريغ شهوةٍ أو نزوةٍ وليدة لحظة. لكنها تركت خلفها أطفالًا يعانون لسنين وعقود.